مدخل
يميل كثير من الناس للتّعاريف الجاهزة البسيطة لبعض المفاهيم
بالغة التعقيد، ومع أهميّة التّبسيط أحيانا، إلّا أنّه “إن تجَاوَز حُدودَه -مثلما
يدفع نحوه نظام التّفاهة- صار خطِراً، لأنه يؤدّي إلى خفضٍ لدرجة الجودة”(2).
ومصطلح الثقافة هو بجدارةٍ واحدٌ من أهمّ المفاهيم التي لا يمكن
الخضوع في تعريفها للتّبسيط، والتي عرفت تحوُّلا بارزا ارتبط بالفلسفة المؤثّرة
والمهيمنة عالميّا.
وهذا المقال سنتناول فيه التعريف العامّ للثّقافة، ثمّ ما طرأ
عليها من تغيُّر في زمن الحداثة وما بعدها.
التعريف العامّ للثقافة.. ثقافة المحافَظَة
يُستعمل مصطلح الثّقافة في سياقات مختلفة، وبالتالي يُحيل على
مجموعة من المعاني، لذلك وَجَب تحديد المقصود هنا من الثقافة في تعريفه
العامّ، قبل الوقوف على مفهوم الثقافة وهي ترتدي جلباب الحداثة أو تصطبغ بصبغة ما
بعد الحداثة.
قد يُقصد بالثقافة معاني ليست ما نقصده منها هنا، مثل تلك التي
ذكرها أندريه لالاند في موسوعته الفلسفيّة، ومن تلك المعاني ذلك “الأقرب من المعنى
الماديّ، تطوّر (أو نتيجة تطوّر) بعض الملكات، ملكات العقل أو الجسد، بدُربة ملائمة.
«الرياضة البدنية» – «ارتياض؛ دربة رياضية خالصة»”(3)، أو ذلك
المعنى الذي يُحيل على “ميزة شخص متعلم، وكان قد طوَّر بهذا التعلم ذوقه، حسّه
النقدي، وحكمه”(4).
المعاني السابقة وغيرها، والتي تجعل من الثقافة مصطلحا مرادفا
للرياضة والدُّربة، أو للعلم والمعرفة، أو للحضارة؛ ليست مقصودَنا هنا من الثقافة.
الثقافة التي نقصدها هي المرتبطة بجماعة بشرية أو مجتمع، وتعني
ذلك المشترك بين جماعة بشريّة، والمميِّز لهذه الجماعة عن غيرها.
فالثقافة بهذا المعنى هي مجموعة من الاختيارات المجتمعيّة؛ فهي
اختيارات وتوجُّهات خاصّة بمجتمع ما وتميّزه عن غيره من المجتمعات. إذن فحين
نتحدّث عن الثقافة فنحن نتحدّث عن حقل دلالي يشمل: جماعة من البشر، اختيارات،
ذاكرة، تراث، ينقسم بدوره إلى تراث مادي ومعنوي… وغيرها من المصطلحات الدّالة
على هذا الحقل والمرتبطة به.
وتشمل الثقافة الأفكار والتقاليد والدين والعادات عند المجتمع.
وقد عرّفت اليونسكو الثقافة بالقول: “تُعتبر الثقافة، بمعناها الواسع، مجموعة
من السّمات المميزة، الروحية والمادية، والفكرية والعاطفية، التي تميّز المجتمع أو
المجموعة الاجتماعية. وتشمل، بالإضافة إلى الفنون والآداب، أساليب الحياة، وحقوق الإنسان
الأساسية، وأنظمة القيم، والتقاليد، والمعتقدات”(5).
فالمجتمع في حالته العاديّة العامّة يمتلك اختيارات ومميّزات
تشكّل هويّته المميّزة المختلفة عن باقي المجتمعات، والجماعة البشريّة تحافظ على
تلك الثقافة بتلقينها للأجيال عن طريق ما يُعرَف بعمليّة التّنشئة الاجتماعية (socialisation)؛ التي هي عمليّة (processus) تعليم
الأفراد القيم والأخلاق والاختيارات المجتمعيّة وإدماجهم في المجتمع وتلقينهم
ضوابط هذا المجتمع.
والثقافة بهذا المعنى كانت هي السائدة قبل زمن التنوير
والحداثة، والذي أظنّه المعنى العامّ للثّقافة في الحالة العاديّة لكلّ مجتمع.
وحول دور هذه الثقافة الضّابطة، يقول الفيلسوف زيجمونت باومان:
“وإذا دققنا النظر في هذه التصويرات والتفسيرات، يتضح أن «الثقافة» (باعتبارها
مجموعة من الاختيارات المقترحة والمرغوبة والمفروضة استنادا إلى صحّتها أو خیریّتها
أو جمالها) كان يعتبرها مؤلفوها «قوة محافظة من الناحية الاجتماعية» في المقام الأول
والأخير. وحتى تُثبِت الثقافة جدارتها في هذه الوظيفة، كان عليها أن تقوم بحيلتين متناقضتين
في ظاهرهما. كان عليها أن تكون توكيدية وحازمة وقاطعة في القَبُول والرّفض، وفي منح
تذاكِر الدُّخول ومنعها، وفي اعتماد بطاقات الهوية وحرمان المواطنين من الحقوق. وإلى
جانب تحديد الثقافة للمرغوب والمحمود، استنادا إلى الواجب (الألفة والراحة)، كانت الثقافة
بحاجة إلى دوالّ للموضوعات التي ستنعدم الثقة فيها ويتم اجتنابها استنادا إلى دونيتها
وخطرها الخفيّ؛ وإلى علامات تحذّر، كما على حواف الخرائط القديمة، بأن هذه مناطق أسود
مفترسة”(6).
إنّ الثقافة هنا، والتي تميّز جماعة بشريّة، تلعب دور المحافظة
على هويّة الجماعة، عبر التحديد الصّارم للقيم والنُّظم المجتمعيّة وتلقينها،
وإخضاع الجميع لسُلطانها وضوابطها.
إنّنا نجد في الثقافة قبل عصر التّنوير، وعيا بحقّ الاختلاف،
وبضرورة المحافظة على التميُّز الثّقافي. ولهذا تأخُذ الثقافة في هذه الحالة على
عاتقها دور المحافظة الاجتماعيّة، وذلك عبر آليّة التحديد الصّارم للنُّظُم
الاجتماعية، وفرض الثقافة على أفراد المجتمع وإلزامهم بها.
أمّا طبقة “المثقّفين” الذين يقومون بهذا الدّور، فقد
كان المجتمع نفسه بما يمارس من سلطة على الأفراد، كما أنّ هناك فئات خاصّة تقوم
بهذا الدّور حسب اختصاصاتها، فالنُّخَب الدينية -مثلا- تتكفّل بالمحافظة على الاختيار الدينيّ للمجتمع كمُكوّن للهويّة
المُجتمعيّة.
لكنّ مصطلح الثقافة لم يعُد بنفس المعنى المذكور آنفا؛ سواء مع
زمن الحداثة أو زمن ما بعد الحداثة. وكان أوّل انقلاب لهذا المفهوم في زمن
التنوير، وتحديدا مع تغلغُل فكرة المركزيّة الغربيّة، وبشائر نهاية التاريخ،
ومزاعم الكمال الحضاري الغربي.
الثقافة ودور المثقف في زمن الحداثة.. ثقافة
“الاستنارة”
إنّ التحوُّلات الاجتماعيّة والثّقافيّة تبدأ من تنظير فكري
فلسفيّ. فحين نتحدّث عن الحداثة نتحدّث بشكل رئيس عن ديكارت؛ باعتباره مؤسّسا
للشّرارة الحداثيّة فلسفيّا. ثمّ تحوّلت هذه الفلسفة إلى مُهيمن على عصر بأكمله هو
عصر الحداثة.
إنّ زمن الحداثة هو الذي هيمن عليه طابع تقديس العقل باعتباره
جوهرا في ذاته، تلك هي السرديّة الأساسية في فلسفة الحداثة، والتي ظهرت مع
الكوجيطو الديكارتي. لكن لا يمكن لنا اختزال الحداثة في هذه السرديّة. فالحداثة
كمُخرَج نهائيّ للنهضة الأوربيّة كانت فلسفة ماديّة ثائرة على الدين، تحمل في
طيّاتها تقديس ومركزيّة الإنسان، وما يرتبط بهذه المركزيّة من ضرورة تسييد (جعله
سيّدا) هذا الكائن الطّاغي على الطّبيعة، وتحقيق رفاهيّته، والقضاء على كلّ الشرور
في العالم.
وقد عبّر المفكّر عبد الوهاب المسيري عن الحداثة بـ “العقلانية
الماديّة الصّلبة”، ووصفها بقوله: “والعقلانية المادية هي الإيمان بأن الواقع
المادي (الموضوعي) يحوي داخلَه ما يكفي لتفسيره دون حاجة إلى وحي أو غيب، وأن هذا الواقع
يُشكِّل كُلًّا متماسِكا مترابطةٌ أجزاؤُه برباط السببيّة الصلبة، بل والمطلقة. وعقلُ
الإنسان حينما يدرك الواقع فإنّه لا يدركه كأجزاء متفرقة متناثرة، وإنما يدركه ككلّ
متماسك، يتجاوز الأجزاء المتناثرة المتغايرة، ويدرك أن حركة الأجزاء ليست حركة عشوائيّة،
وإنّما هي تعبير عن هذا الكلّ الثابت المتجاوز، ولذا فهي حركة لها معنى وهدف، ولها
معياريتها ومعقوليّتها، فما يحدث يحدث حسب قانون مطّرد ثابت وليس بالمصادفة العمياء.
وقد ترجمت هذه العقلانية المادية نفسها إلى ما يسمى (حركة الاستنارة)،
التي ذهبت إلى أن عقل الإنسان قادر على الوصول إلى قدر من المعرفة يُنير له كل شيء،
أو على الأقل مُعظَم الأشياء والظّواهر، ويتعمق من فهمه للواقع ولذاته وكان الافتراض
أن هذه المعرفة هي التي تُضفي على الإنسان مركزيةً في الكون، وهي التي ستمَكِّنه من
تجاوُز عالَم الطبيعة بل وذاته الطبيعية، ومن تغيير العالم والتحكُّم فيه، بحيث يُصبح
الإنسان إلها أو بديلا للإله أو لا حاجة به إليه”(7).
بالإضافة إلى هذا كانت الحداثة تبشِّر الكائن البشري بنهاية
التاريخ والمركزية الغربية؛ مركزية الإنسان الأبيض الغربي وحضارته كآخر تطوُّر
عرفه وسيعرفه الإنسان. وبالمناسبة، فإنّ فرضيّة التطوُّر هاتِه يمكن اعتبارها
ركيزة أساسيّة، قامت عليها فكرة مركزيّة الغرب؛ فهذا الكائن الأوربيّ هو ذلك الجنس
الأكثرُ تطوّرا من نسل القرَدَة العُليا، والحضارة الإنسانيّة بدورها في تطوُّر
صاعِدٍ متراكِم يُمثّل الإنسان الغربيّ وحضارتُه آخر تطوّراته.
لقد “اقترنت ولادة «العصر الحديث» مع الممارسة الغربية في
ميادين المعرفة، والصناعة، والاكتشافات الجغرافية، وبناء مؤسسة الدولة بركائزها
الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والسياسية. لقد جرى تأويل العالم على أنه حقل غربي لا يجوز لغير الغربيين الانتفاع
بخيراته. وأفضى كلّ ذلك إلى نوع من التمركز حول الذات بوصفها المرجعية الأساسية
لتحديد أهمية كلّ شيء وقيمته، وإحالة «الآخر» إلى مكوّن هامشي”(8).
ولأجل هذا الاقتران بين الحداثة والمركزيّة الغربيّة تغيّرت
الثقافة وأدوارُها، فإنّ دور (المحافظة) الذي كان منوطا بالثقافة تغيّر لدور آخر
يمكن التعبير عنه بدور (التّقليد) للثقافة الغربيّة المركزيّة.
يربط الفيلسوف زيجمونت باومان هذا الانقلاب بكتاب التميز (Distinction) لعالم الاجتماع بيير بورديو، الذي أعاد تعريف الثّقافة، ويرصُد
لنا هذا الانقلاب في مفهوم الثقافة والدّور المَنوط بها بقوله: “وكان الغرض من
«الثقافة» وِفق مفهومها الأصلي(9) أن تكون عامِلا للتّغيير وليس عاملا للحفاظ
على الوضع القائم، فكان المطلوب منها أن تكون وسيلة لقيادة التطوُّر الاجتماعي نحو
وضع إنسانيّ عالمي. ولم يكُن الغرض الأصلي لمفهوم «الثقافة» توظيفها كدفتر يختص بتسجيل
توصيفات الموقف السّائد، ولا سرد قائمة بالأشياء التي يحتويها، ولا جمع قوانينه وتصنيفها،
بل تحديدُ هدف الجهود المستقبلية ووِجهتها. لقد أسندت كلمة «الثقافة» إلى رسالةٍ رَعَويّة
جرى تخطيطها والقيام بها في شكل محاولات لتعليم العوام والارتقاء بعاداتهم، ومن ثم
تحسين المجتمع وتطوير «الشعب»، من أعماق المجتمع» إلى «قمم المجتمع». فكانت «الثقافة»
ترتبط بشُعاع التّنوير» الذي يَصِل إلى خبايا المدينة والريف ليَكشِف عن الغَيَابات
المُظلِمة للتّحامُل والخُرافة التي لا يمكنها أن تبقى على قيد الحياة إذا ما تعرضت
لضوء النهار مثل مصّاصي الدّماء كما ساد الاعتقاد. وقد عبّر ماثيو أرنولد عن رأي حماسي
في كتابه المؤثر للغاية وعنوانه الكاشف الثقافة أو الفوضوية (Culture or Anarchy)
(1869)، قائلا: إن الثقافة تسعى إلى التخلُّص من الطّبقات، وإلى نشر أفضل الفكر والمعرفة
في العالم في كل مكان، وإلى تهيئة الناس جميعا للعيش في جو من اللطف والحب». وفي مقدمته
لكتاب الأدب والدوجماطيقا (Literature
and Dogma) (1873) يذهب ماثيو أرنولد إلى أن الثقافة هي
مزج الأحلام والرغبات الإنسانية بكدح المستعدين والقادرين على تحقيق هذه الأحلام
وإشباع هذه الرغبات: «الثقافة هي الشغف باللطف والحب، والأهم هو أنها الشغف بالعمل
على سيادتهما».
دخلت «الثقافة» قاموس المفردات الحديثة باعتبارها إعلانا للنيّات،
واسماً لرسالةٍ لا بُدّ من القيام بها. وكانت «الثقافة» وحدها كلمةً برّاقة ودعوة للفعل.
وكانت الثقافة مثل المفهوم الذي كان صورة مجازيّة لوصف هذه النية (أي مفهوم «الزراعة»
الذي يربط المزارعين بالحقول التي يزرعونها)؛ كانت الثقافة دعوةً للفلاح الذي يحرث
الأرض والذي يبذُر البذور بأن يحرث الأرض العاقر ويبذر فيها البذور ويُثريَ المحصول
بالفلاحة (بل إن شيشرون استخدم هذه الصورة المجازية ووصف تربية الصغار بأنها فلاحة
الروح والعقل cultura amini). لقد افترض
هذا المفهوم تفرقة بين المعلمين المعدودين الذين يُدْعَوْن إلى تثقيف الأرواح والكثرة
موضع التثقيف؛ بین الأوصياء والقُصَّر؛ بين القادة والمَقُودین؛ بين المعلِّمين والمتعلّمين؛
بين المنتِجِين والمُنتَجات، بين الذّوات الفاعلة والموضوعات المستهدَفة من الفعل.
– علاوة على اللقاء الجامع بينهما”(10).
ومنه فقد تحوّلت الثقافة في زمن الحداثة من المحافظة على الوضع
الموجود؛ على الاختيارات المجتمعيّة لمجتمع ما، إلى حالة محاولة السُّموّ بالشعوب
وعامّة الناس إلى وضع معرفيّ وثقافيّ تُمثّله طبقة من المثقّفين الذين وُضعت على
عاتقهم مسؤوليّة تثقيف وتنوير المجتمعات لتصبح متحضّرة ولتنفض على عقولها غُبار
التخلُّف والخُرافة، ولتواكب ركب التحضُّر والرّقيّ. لقد “كانت الثقافة تَنِمُّ
عن اتّفاق مرسوم ومتوقّع بين العارفين (أو على الأقل الواثقين بامتلاك المعرفة والجاهلين
(أو على الأقل المَنعُوتین بالجهل من جانب الطامحين الواثقين في قدرتهم على تعليمهم
والقضاء على جهلهم). إنه
اتّفاق مُزَوَّد بمحض المصادفة بتوقيع واحد ووحيد، يلقى تأييدًا أُحاديّ الجانب، ويجري
تحقيقه تحت الإدارة الحصرية التي تمثلها «الطبقة المتعلِّمة» الجديدة، الساعيةُ إلى
امتلاك الحقّ في تشكيل النظام الجديد المُعدَّل»، البازِغ من رماد النظام القديم البائد.
وكانت النّيَّة المُعلَنَة لهذه الطّبقة هي تعليم العامة وتنويرهم والارتقاء بهم وتهذيبهم
باعتبارهم المستقبِلين الجُدُد لدَوْر مواطنـي الأمة/الدولة الجديدة، ذلك الكيان المزدوج
الذي ارتقى بنفسه إلى مرتبة الوجود السياديّ للدولة، مع تطلُّع الدولة الجديدة إلى
دور المؤتمَن على تلك الأمّة وحاميها وواصيها”(11).
لقد كان هناك أشبهُ بعَقد بين الدّولة والمثقّفين الذين سيعملون
على عمليّة شبيهة بفلاحة الأرض؛ هي توعية عامّة الناس وتنويرهم. وقد وجدت الدول
الأوربيّة في عصر التّنوير حاجة ملحّة إلى أراضٍ جديدة للاستعمار مع الفائض
البشريّ، “واتّضح أن أُفُق استعمار الأراضي متراميةِ الأطراف هو باعثٌ قويٌّ على
فكرة التنوير الذي تقوم به الثقافة، وأضفى على الرسالة الرَّعَويّة بُعداً جديداً تماما
وعالميّا. ففي صورة مِرآويّة لفكرة تنوير الشّعب، تَشكَّل مفهومٌ عن «رسالة الرّجل
الأبيض»، وعن «إنقاذ البرابرة من حالتهم البربرية». وسُرعان ما اكتَسَت هذه المفاهيم
بتعليق نظريّ في صورةِ نظريةٍ ثقافيّة تطوُّرية ارتقت «بالعالم المتقدِّم» إلى مرتبة
الكمال القاطع الذي لا بدّ أن تُقَلِّدَه عاجلاً أم آجلاً بقيّة بلدان العالم وأن تطمح
إليه. وفي السّعي لتحقيق هذا الهدف، كان لا بد من مساعدةٍ نَشِطَة لبقيّة بُلدان العالم،
وفي حالة المقاومة، كان لا بُدّ من قهرها. هذه النظريّة الثقافية التطوُّرية أَسندَت
إلى المجتمع «المتقدّم» تحويلَ بقيّة سكّان العالم إلى هذا »الدين
الجديد».
وهكذا جرى اختزال كل مبادرات الثقافة وأعمالها المستقبليّة في الدّور
الذي ستلعبه النُّخبة المتعلّمة في العواصم الكولونيالية للارتقاء «بعامة الناس الشعب»
في العواصم الكبرى.”(12).
هكذا إذن أصبحت الثقافة تعني “تعليم البرابرة”
التحضُّر الغربيّ، وتمّ اختزالها في مسؤوليّة التّثقيف هاته التي تقلّدها النُّخبة
المثقّفة؛ التي هي في الحقيقة طبقةٌ من الّذين قاموا بغَزو الدُّوَل ثقافيّا
وفكريّا، بعد الغزو العسكريّ. فما دام الغزو العسكريّ يخلُق مُمانعةً قويّة ويزيد
من هذه المُمانعة، فإنّ الغزو الفكريّ النّاعم سيكسر هذه المُمانعة، ليس هذا فحسب،
بل سيجعل المجتمعات تَقبَل الغزو العسكريّ، بل وتطالب به أحيانا!
وهذا الدّور للثّقافة يظهر بجلاء في قول “عميد الأدب
العربي” تحت عنوان “وجوب الصّراحة في الأخذ بأسباب الحضارة
الأوربية” في كتابه “مستقبل الثقافة في مصر”؛ وهو يُوجِب على نفسه
إعلان الصّراحة: “لكن السّبيل إلى ذلك ليست في الكلام يُرسَل إرسالًا، ولا في المظاهر الكاذبة والأوضاع
الملفَّقة، وإنما هي واضحة بَيِّنة مستقيمة ليس فيها عِوَج ولا التِواء، وهي واحدة فذّة ليس
لها تعدُّد، وهي أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادًا، ولنكون لهم
شركاء في الحضارة، خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يُحَب منها وما يُكره، وما يُحمد منها وما يُعاب. ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع”(13).
إنّ هذا القول من طه حسين لمُحاولةٌ ليس لتثبيت الثقافة الغربيّة في الوطن العربي،
بل لِخلق الشجاعة لدى الناس في قبولِ الصّريحِ الفَخور عندهم بعد القَبول العمليّ
والنّفسي، فهو يقول: “والغريب أنا نسير هذه السيرة ونذهب هذا المذهب في حياتنا العملية اليومية، ولكننا نُنكِر ذلك في ألفاظنا وعقائدنا ودخائل نفوسنا، فنتورّط في نفاقٍ بغيض لا أستطيع أن أسيغه ولا أن أسكن إليه”(14).
ونجد عند مفكرين آخرين محاولة واضحة للعب هذا الدّور للثقافة في
عصر الحداثة، بتبنّي الحداثة الغربيّة أوّلا، والدّعوة إليها ثانيا؛ إمّا بشكل
صريح كما رأينا عند طه حسين، وبشكل مُستبطَن، باستدعاء رموز من الثقافة الإسلاميّة
ومحاولة نسبة الفلسفة الحداثيّة إليهم، ليظنّ النّاس التّوافق بين الإسلام
والحداثة، ومثال ذلك محمد عابد الجابري.
ويعبّر عن هذا الدّور المنوط بالمثقّفين الحداثيّين زكي نجيب
محمود فيما أسماه (أشدّ معضلة تتحدّى المثقّف العربي) بالقول: “إنني لا أرى -بين المعضلات التي تتحدَّى المثقف العربي في زماننا- ما هو أشدّ تعقيدًا
وأعسر حلًّا، من محاولته أن يجمع طرفين، يكادان يكونان متضادَّين، في صيغة حياتيّة
واحدة، ألا وهُما المحافظة على هويّته التاريخية من جهة، والحرص
-في الوقت نفسه- على أن يعاصر دُنياه التي تعُجّ من حوله بمخابير المعامل وعجلات المصانع؛ إن المثقف العربي على وعي كامل بما يريده في هذا المجال، وهو الجمع بين هذين الطرفين جمعًا لا يداخله القلق”(15).
وإذا أخذنا بعين الاعتبار هيمنة الثقافة الغربيّة الحداثيّة
وسُلطتها، عرفنا أنّ هذا الجمع الذي ذكره زكي نجيب محمود بين التراث والحداثة الذي
يمارسه المثقّفون لا يمكن أن يكون إلّا بإخضاع التّراث للحداثة، وتقديم التراث
بحياء كبير وتخوُّف أمام الحداثة، والتبرير له ومحاكمته على أساسها. وزكي نجيب
محمود يصرّح بنفسه أنّ هذا فعلا هو الحلّ الأمثل لهذه المعضلة، فيقول:
“فهؤلاء المتعلِّمون يقعون في مجموعاتٍ ثلاث: إحداها تريد تحقيق الهدف
بأن تجعل ثقافتنا
الموروثة هي معيار الصواب والخطأ، فما اتفق معها قَبِلناه، وما تعارض معها رفضناه؛
والثانية تريد تحقيق الهدف ذاته بأن تجعل الثقافة الغربية العصرية هي معيار الصواب
والخطأ، فما اتفق معها من تراثنا أبقيناه، وما خالفها من ذلك التراث أهملناه، وأما
المجموعة الثالثة فهي وحدَها التي تتصدَّى بحقٍّ للمُشكلة التي تتحدّانا؛ لأنها أرادت أن تحقِّق الهدف نفسه، ولكن بالبحث عن صيغة جديدة تضم الطرفين معًا”(16).
مع دخولنا فترة “ما بعد الحداثة” أو “الحداثة
السّائلة” حسب باومان أو “إعادة كتابة الحداثة” كما يحلو لفرانسوا
ليوتار -أحد أبرز فلاسفة ما بعد الحداثة- تسميتها؛ عرفت الثّقافة انقلابا جديدا.
الثقافة في حُلّةٍ ما بعد حداثيّة.. ثقافة السُّيولة
والفردانيّة
قبل أن نتعرّف على رأي فلسفة ما بعد الحداثة في الثقافة بمعناها
الحداثيّ، لا بدّ من الوقوف على ملامح ما بعد الحداثة ولو باختصار مُخلّ.
إنّ إخفاق الحداثة في تحقيق رهاناتها، مع النّقد الفلسفي
المتوجّه لأفكار حداثيّة مركزيّة، مثل نقد العقل، خاصّة مع كانط، وموت مركزيّة
الإنسان بعد توجُّه رصاصات كوبيرنيك
وداروين
وفرويد إليها؛
كان لها أثر بارز في ظهور تيّار مُعارِض انتقد الحداثة وارتدّ عنها ردّة متطرّفة
شملت حتّى الضّرورات العقليّة. فقد بشّرت الحداثة بفردوس أرضيّ يكون فيه الإنسان
إلها، في حين انتهت الحداثة إلى استعمار واستعباد الأمم والشعوب، وتُوِّجت بحربين
عالميّتين لا مثيل لمُخَلَّفاتها في التاريخ. وقد تأمّل عدد من الفلاسفة هذه
المُنتجات الحداثيّة فرأَوا في البشائر الحداثيّة أشبه بضحكاتٍ شرّيرة لسفّاح على
أشلاء القتلى وجماجمهم. وأنا أولي هنا الحربين العالميّتين أهميّة بالغة في
الانقلاب ما بعد الحداثيّ، لوُضوح أنّ أدبيّات تيّارات ما بعد الحداثة كانت ردّة
فعل واضحة على الحروب التي كانت، وفي هذا، بالمناسبة، الأهميّة الفكريّة للموت
وتأثيره، كهادم للّذات، يُظهر للعقل قصوره ويشغل الفكر بما يخفى عليه من حقيقة
الوجود. فـ “يجب إذًا النظرُ إلى تلك الثقافة باعتبارها نتيجةً طبيعيةً لما مرَّ
به الغرب من تناقُضات وانقسامات في الأيديولوجيات الحداثية، لا سيما في علاقة المركز
بالهامش وما نشأ عنها من قِيَمِ الاستغلال والاستعمار، وغياب المساواة، وسيطرة النخبة
…إلخ. ومن ثَمَّ من الطبيعي أن تنشأ، كنوع من ردة الفعل، اتجاهاتٌ مُضادّة، تُنادي
بسقوطِ الأيديولوجيات، والسرديات الكبرى، ونهاية الميتافيزيقا، وتُطالِب بالخروج عن
كل قياس معياري، وترسيخ مبدأ الانتماء الفردي، وربما تشيع أيضًا ملمح الثقافة السِّلَعية
الاستهلاكية، ورفض مقولات وفرضيات عصر التنوير، وخطاب الحداثة المُتمثَّل في الإيمان
المُطلَق بالعقلانية الشمولية”(17).
وقد شكّلت ما بعد الحداثة رؤية منفصلة للعالم، بحيث “تقدّم
ما بعد الحداثة نفسها -كما هو شأن الحداثة- كنموذج عقلاني نظامي. أنها تتحدى
المنظور العالمي للتنظيم الاجتماعي، وللقانون بسماته وخصائصه التي تحدّدها
الوضعيّة القانونية، وللحتمية الآلية الكامنة خلف التنظيم القانوني الحديث”(18)،
كما “تتأسس ما بعد الحداثة على شبكة من المفاهيم التي تقوم محصّلتها بتشكيل
علائقها النموذجية. وهذه المفاهيم هي النّفعيّة والنّسبية ولامركزية الذات
وتعدديّة الآراء وتعدّد المراكز والمنطقيّات المفصّلة والتعقيد وإعادة اكتشاف
الزمن في أبعاده الثلاث (الماضي – الحاضر – المستقبل)”(19).
وعلاقة ما بعد الحداثة بالحداثة لا تنحصر في الانقلاب والتّضادّ
فقط، بل تتحدّد في كون ما بعد الحداثة صيرورة طبيعيّة للحداثة كذلك؛ ذلك أنّ
الأرضيّة الماديّة الصّلبة التي قامت عليها الحداثة كانت أساسا هشّا، وجعلت
السرديات الحداثيّة بدون أساس موضوعيّ، إذ كانت مستندة للذّاتيّة، “إلّا أنّ
هذه الذّات ومصنوعاتها رقيقة وواهنة؛ ولن تقوى على الصّمود كثيرا، إنّها تُشبه
السّفينة التي تُشرف على الغرق ولا تستطيع أن تُلقي مراسيها عند نفسها، بل لا بدّ
من أرضٍ صلبة تُلقي عندها هذه المراسي كي تأمن الغرق، وكذا الذّات الإنسانيّة لا
بدّ لها من أرض صلبة تتّكئ عليها لتنجو من الطّوفان”(20). يقول
الدكتور الطيب بوعزة: “ومع انتهاء القرن التاسع عشر تبدى بوضوح أن الحداثة
عندما أسقطت المرجعية الدينية، أسقطت نفسها في مأزق، حيث أقامت العقل بوصفه مرجعا
أحاديا للحقيقة الفلسفية ومنبع التنظير للنظم السياسية، ثم لم تستطع أن تحقق
للكائن الإنساني مطالبه وتستجيب لانتظاره، فكان لابد أن تشهد نهاية القرن التاسع
عشر لحظة مراجعة شاملة للأسس الإبستمولوجية التي قامت عليها الحداثة. ولم تكن المراجعة ممارسة
نقدية محدودة بل كانت ثورة وانقلابا على فلسفة الحداثة بكل تجلياتها. وإذا كان المشروع الحداثي
من حيث الأساس إعلاء من شأن الذات الإنسانية وقدراتها العقلية، فإن ما بعد الحداثة
كان ضربة موجهة بالضبط إلى هذا الأساس وتفكيكا له، أي نقض العقل ونفي الذات”(21).
يتبيّن من هذا أنّ ما بعد الحداثة كانت صيرورة للحداثة؛ لقيام
أساس بُنيان هذه الأخيرة على شفا جُرُف هارٍ انهار أمام النّقد المتواصل، وفي نفس
الوقت كانت انقلابا عليها. حيث أنّ تلك الوُثوقيّة والصّلابة التي كانت تتمتّع بها
السّرديّات الكبرى والأيديولوجيات انقلبت إلى غاية السُّيولة والنسبيّة. والثقافة
هي بالتَبَع اكتسبت هذا الطّابع السائل والفردانيّ.
لقد استعار باومان حالة فيزيائيّة للمادّة في علم الكيمياء،
ليصف بها حالة ما بعد الحداثة في ثقافتها، ليعبّر عن اضمحلال وذوبان كل المعطيات
التي هيمنت على زمن الحداثة من نماذج ثقافية واجتماعيّة جاهزة تدّعي الكمال
والتطوُّر الأقصى والنّهائي للبشريّة، وينبغي الحذو نحوها وتقليدها وتعميمها
وعولمتها.
ويعرّف باومان السيولة ويفسّرها بقوله: “وصدر فقدان
المكانة(22) عن عمليات شكّلت تحوُّل الحداثة من مرحلة الصّلابة إلى
مرحلة السُّيولة. وأستخدم هنا مصطلح (الحداثة السائلة) liquid modernity للإشارة إلى الشكل الراهن للوضع الحديث الذي يصفه مؤلفون آخرون
بأنّه (ما بعد الحداثة) postmodernity، أو (الحداثة المتأخرة) late modernity، أو (الحداثة الثانية) Second modernity، أو (الحداثة العليا) hypermodernity. إن ما يُحوّل الحداثة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة،
ويبرّر اختيارنا لهذه الصفة، هو (التحديث) الوسواسي القهري المكثف، الذي أفضى إلى
عدم قدرة أي من أشكال الحياة الاجتماعية المتتالية بأن تحتفظ بشكلها زمنا طويلا،
تماما مثل المواد السائلة. فـ(إذابة كل ما هو صلب) كانت السّمة الجوهرية المميزة
للشكل الحديث للحياة من البداية، ولكن اليوم، على عكس من الأمس، لا يحل محلّ
الأشكال المذابة أشكال صلبة أخرى، تلك الأشكال التي كانت تعتبر (مُعدّلة)، بمعنى
أنها أكثر صلابة ودواما من الأشكال السابقة عليها، بل وأكثر مقاومة للذوبان. ومحل
الأشكال الذائبة غير الدائمة تحل أشكال أخرى، ليست أقل قابلية للذوبان إن لم تكن
أكثر قابلية للذوبان، ومن ثم فهي غير دائمة بالقدر نفسه”(23).
إنّ ثقافة ما بعد الحداثة ثقافة انتهى
معها التنظيم والضّبط المجتمعيّ، الدّورُ الذي ظلّت الثقافة قبل ذلك محافِظة عليه؛
إذ لم تعُد هناك ثقافة متناسقة حاكمة، وانتهت النّماذج، وأصبحت الهويّة المجتمعيّة
مُغرِقة في الفردانيّة، حيث تتشكّل الثقافة اليوم “بما يُلائم الحريّة
الفرديّة للاختيار والمسؤوليّة الفرديّة عن ذلك الاختيار”(24)
وجرى تعيين الفرد “في منصب المدير العامّ «لسياسة الحياة اليومية» ومديرها
التنفيذي الوحيد”(25). أي أنّ الثقافة قد فقدت فعليّا وظيفتها، فقد
“طُردت من دورها باعتبارها وصيفة الأمم والدول والتراتُبيات الاجتماعية المقرِّرة
لمَصائرها والمؤكٍّدة لذواتها”(26).
لقد أصبحت الثقافة متشكّلة حسب منطق
الفرد، حيث تحضُر أهواؤه ومُتَعُه وحريّاته الفرديّة، وتتماهى الثقافة مع مطالب
الفرد التي يفرضها حتى على القانون، ويتم في ظل هذا تشجيع التعبير عن مزيد من الآراء
ومزيد من الاختلاف والتنوُّع والاهتمام بالمُتَع الفرديّة،
ففي مجتمع ما بعد الحداثة تُصبح
الثّقافة المجتمعيّة النّمطيّة هي كون “المجتمع يشهد ديناميكية التّفريد individualisation”(27)، بحيث نعيش في “مجتمع جعل من الفرد
الحر قيمة أصلية”(28) و”يكون الفرد مجرد عضو من أعضاء
كثيرين، مجرد إنسان من بين هؤلاء البشر الكثيرين الذين يحيطون به، ممن يعرفهم ومن
لا يعرفهم، وهؤلاء البشر هم من يتوقّعون منه، ومن كل واحد غيره يعرفه أو يسمع عنه،
أن يقدّم دليلا قاطعا يثبت أنه فرد، يثبت بأنه خُلِق أو خَلَق نفسَه ليكون «مختلفا
عن غيره»، فالامتثال
هنا لواجب الانشقاق والاختلاف لا يجرُؤ أحد على الانشقاق عنه ولا الاختلاف عليه.
ففي مجتمع الأفراد، لا بد من أن يكون
كل عضو من أعضائه فردا؛ وهنا على الأقل تنتفي عنهم صفة الفردية والاختلاف والتفرد،
بل إنهم، على النقيض من ذلك، متماثلون تماثلا كبيرا؛ فجميعهم لا بد من أن يتّبعوا
استراتيجية الحياة نفسها، وأن يستخدموا رموزا مشتركة يسهل إدراكها وقراءتها فيما
بينهم لإقناع غيرهم بأنهم يتّبعون استراتيجية واحدة. فليس هناك من اختيار فردي في
قضية الفردية، ولا صراع داخلي على صورة (أكون أو لا أكون).
وتكمن المفارقة في أن (الفرديّة) مسألة
مرتبطة (بروح الجمع الغفير)، ووفق مطلب يفرضه بالقوة جمع غفير”(29).
ومع كون الفرد الحرّ قيمة أصيلة في
المجتمعات المعاصرة، تغيّرت أساليب الثقافة وآلياتها، فبينما كانت الأجهزة
الثقافية (التعليم، الإعلام، الفن، النُّخب..) تتعامل مع “عامّة الناس”
بمنطق الواجب والقواعد لإقناعهم، أصبحت تتعامل بمنطق الإغراء والاقتراح،
حيث “تتألف الثقافة اليوم من العروض المُغرية لا من التحريمات، إنّها من
الاقتراحات لا من القواعد. وكما لاحظ بيير بورديو، فإنّ الثقافة اليوم تنخرط في
وضع إغراءات ومفاتن، بالسحر والإغواء لا بالضّبط والرّبط؛ بالعلاقات العامّة لا
بالمراقبة البوليسيّة؛ بإنتاج حاجات ورغبات وبذرها وغرسها لا بالواجب”(30).
لقد اعتبر فلاسفة ما بعد الحداثة ذلك التقسيم
“الطّبقي” للناس على أساس “الغنى المعرفيّ” إلى مثقّفين/نُخَب
وعامّة الناس نوعاً من الاستعباد الحداثيّ الذي يجب التحرُّر منه. وبناءً على هذا
جرى التأسيس لمنطق الفردانيّة. وأصبحت قيمة الأشياء لا تُكتسب من كونها خيّرة في
ذاتها، بل من قيمتها الاستهلاكيّة النفعيّة والتبادُليّة الرأسماليّة. فقد “غزت
الرأسمالية كل مكان، فكل ما يقبل التبادل يندمج في الرأسمال بسرعة، بمُجرّد ما أن يقبَلَ
التحوُّل من مالٍ إلى آلة، من بضاعة إلى بضاعة، من قوة عمل إلى عمل، من عمل إلى أجر
ومن أجر إلى قوة عمل.
فالقانون المسيطر هو قانون القيمة، لقد انتهت إيديولوجيا الثقافة
التي طالما آمن بها المثقفون والمبدعون والفنانون المنتمون إلى عصر الحداثة، حينما
وضعوا على كاهل المثقف «إعادة الاعتبار للغايات الكونية الإنسانية»، و«استغلال الرأسمال
المعرفي للسمو بالثقافة الشعبية» (سارتر) التي تُعاني من جراثيم الإيديولوجيا والوهم
والاستعباد، فلا يمكننا اليوم أن ندّعي بحسب ليوتار في تعليقه على كتاب Guattari و
Deleuze «ضد أوديب» أن إنتاج موضوع-شيء يتم تحت شرط أنه ضروري
وجيّد في ذاته، لأن قيمة منتوج أو موضوع إبداعي تتحدّد في مدى قابليته للتبادل (l’échangeabilité)”(31).
لقد أصبحنا نتحدّث إذن عن انتهاء كلّ الأدوار التي كانت تضطلع
بها الثقافة، سواء دور “الضّبط المجتمعي” أو “الحفاظ على ما هو
سائد” -كما كان قبل الحداثة- أو “التطوُّر لبُلوغ الكمال الأوربي”
-كما كان في زمن الحداثة-. وأصبحت الثقافة تابعةً لأهواء الأفراد وحُرّيّاتهم
ومُستجيبةً لها، وتم إلغاء كل ما كان مُحدَّدا على نحوٍ صارِم كالأدوار
الاجتماعيّة للذّكر والأنثى التي عرفت ذوبانا، فإنّ “عمليّة الشخصنة تتجه في
كلّ مكان إلى رفع القيود وتخفيف الأطر الصّارمة”(32). وحتّى على
المستوى الفرديّ؛ لم يعُد هناك اتّساق ونموذج يحكم الفرد، لقد أصبح التناقض
والسّرقة من القيم والثقافات المختلفة والتّلفيق بينها ميزة أساسيّة.
ومع تزايُد أهميّة الفرد وحريّته، أصبحت السُّيولة والتّكَتُّم
و”الحميميّة” قِيَما مركزيّة. فما ليس فردانيّا في زمن ما بعد الحداثة
هو الفردانيّة نفسُها والتحرُّر والاختلاف التي يفرضها المجتمع على أفراده، وما
يظلُّ صلبا في الزمن المعاصر مع سيلان كلّ النماذج والأيديولوجيات هو السُّيولة
نفسها بما تتضمّن من قِيَم التسامح والقَبول والتّعايُش والمُسالمَة. “إنّ
عمليّة الشخصنة لا تُلغي القوانين وإنّما تُذَوّبها مع فرض قواعد جديدة تكون
مُكَيَّفة مع ضرورة إنتاج شخص مُسالِم. يُمكن أن تقول كل شيء ولكن دون صراخ، ويمكن
أن تقول كل ما تريد لكن لا تَمُرّ إلى الفعل. إنّ هذا التّحرير للخطاب، وإن كان
مصحوبا بعنف لفظي، هو الذي يساهم في انكفاء استعمال العنف الجسدي. هناك توظيف هائل
للكلمة الحميمية، وبالموازاة هناك تخلٍّ عن العنف الجسدي، وبهذا الانتقال يبدو
التعرّي النفسي كأداة تحكُّم اجتماعي وإحلال للسِّلم”(33).
خاتمة.. نحو وعيٍ بالواقع الكوني وبناءٍ للتصوُّر الشرعي
لقد تغيّرت الثقافة تغيُّرا جذريا؛ فكانت تعني مجموع الاختيارات
المجتمعيّة التي تُشكّل هويّته وتقوم بدور الضّبط والمحافظة، وأصبحت مع
“الاستنارة الغربيّة” تعني الارتقاء بالثقافات البربريّة للتّحضُّر
الغربيّ، وأُسندت مهمّة الارتقاء هذه للنُّخب الثقافيّة الحداثيّة، ثمّ أصبحت
الثقافة اليوم متحرِّرة من كلّ سلطة؛ “فقد كانت ثورة ماي 1968، اللحظةَ
الثالثة لتخلُّص أوربا من الدين المسيحي في العصر الحديث، وذلك بعد لحظَتَي الثورة
الفرنسية في نهاية القرن 18، والثورة البُلشُفيّة في بداية القرن 20؛ فقد مارس
الثُّوّار خلال الانتفاضة، والفلاسفة التّفكيكيُّون المنبثقون منها فيما بعد، جميع
آليات التّفكيك والهدم للبقيّة الباقية من القيم الدينيّة التقليديّة في العقليّات
الأوربيّة. وكان على رأس القِيَم التي تمّ إسقاطُها: السُّلطة، كيفما كانت. سلطة
رجل الدين على أتباعه، والبرجوازي على البروليتاري، والأستاذ على تلاميذه، والأب
على الأسرة، والزوج على زوجته، والرّجُل على المرأة. وبالمُقابل مُجِّدَت
المساواة، ورُفِعت فوق القيم جميعها: المساواة بين الرجال والنساء، بين الآباء
والأبناء، بين المثليين والمتغايرين، إلخ. والشيء الوحيد الذي سلِم من هذا الجُهد
التّفكيكيّ هو السوق، والنّزعة الاستهلاكيّة الطّاغية”(34).
وتعبّر سوزان ماير بشكل دقيق عن واقعنا المعاصر قائلة:
“وليس من العَجَب أن يشعُر عالمُنا بعدم الانتظام. ففي السنوات الأخيرة من القرن العشرين تقول
النبوءات أنّنا نقف عند نقطة فاصلة بين تراجع نموذج قديم وبُروز نموذج جديد. وتبدو
هذه المرحلة غيرُ مستقرّة ومليئة بالتّناقضات لأنّها تتضمّن خصائص من الحداثة ومن
المستقبل ما بعد الحداثي. إنّ مشاعر عدم الاستقرار المُصاحِبة لإحساسٍ مُلِحّ تزيد
من قلقنا.
وهناك شُعُور أكثر حِدّةً بتحوُّل النموذج على المستوى الشخصي،
فنحن نعيش في حقبة مليئة بالمخاوف والتوتُّرات النفسيّة. وهذه التّوتُّرات قد تنشط
على مستوى اللاوعي وتؤدّي إلى مشاعر حادّة من الإحباط والغضب والارتباك. نحن نُدرك
أنّ شيئا ما يحصل، وأنّ بعضا من افتراضاتنا الأساسيّة -وغير المشكوك بها- حول
طبيعة العالم الذي نعيشه وطبيعة العلاقات الإنسانية تواجه التحدي. وقد يشعر الفرد
على المستوى الشخصي بأنه غير مُحَصَّن وبأنّ الآخرين يُسيئون فهمه، ويتساءل لماذا
أصبحت القِيَم التي كانت تؤلِّف أساس أنظِمَتِنا الاعتقاديّة في موضع الشّكّ
فجأة”(35).
ولذلك، فإنّ ثقافة ما بعد الحداثة تعمل بكلّ أجهزتها على إخضاع
الناس للاعتقاد بعدم وُجود حقيقة مطلقة وموضوعيّة، وتقوم على إجبارهم على المساواة
والتّسامُح المُفرِط مع الجميع، الذي لا يقِف عند احترام حقّ الاختيار فقط بل
الاحترام والمُداهَنة وعدم المساس بحقّ الآخر في الكُفر والفُجور بأمرٍ أو نهي.
فنحن أمام جِهازٍ ثقافيّ يسلِب منّا حقّ الاستعلاء الإيماني كونُنا على حقّ، ويسلب
من قلوبنا كلّ مُمانعة، ويعمل على جعلِنا نتطبّع مع الشذوذ عن الفطرة.
وأمام هذا، لا بدّ أن نعلم:
- أوّلا: أنّ هذه النّزعة التحرُّريّة من الضَوابط
والتي تُساوي بين العالِم والجاهل والمؤمن والكافر، وبين صاحب المسؤوليّة
والرعيّة، وتقوم على التسامُح مع الجميع والتّودُّد إليهم باعتبارهم أفرادا ليس
فقط من حقّهم التّحرُّر والاختلاف بل واجبا عليهم.. أنّ هذه النّزعة مشكلة وأزمة
إنسانيّة حقيقيّة في العصر الحاضر.
- ثانيا: أنّ الحلّ لا يحتاج إلى اختراع أو وحي جديد،
بل هو موجود بيننا في كلام ربّنا وسنّة نبيّه اللّذان لا يأتيهما الباطل من قُبُلٍ
أو خَلْفٍ. وأنّ الإسلام كما فصّل الأحكام للمؤمن بهذا الدين، فقد اشتمل على
القواعد العقليّة والأصول الكبرى لحلّ الإشكالات، وهذا من كمال الوحي، لذلك كان من
لجأ لقياسات عقليّة ظنيّة وترك ما في الوحي مُتّهما للوحي بالنُّقصان. والذي يحتاج
لابتكارٍ هو الأساليب الجديدة في تقديم مضمون هذا الوحي.
- ثالثا: أنّ التصوُّر الشّرعي الصّحيح مَنُوط بالوعي
والإدراك الصّحيح للواقع كما هو عليه، فالحُكم على الشّيء فرع عن تصوُّره. وهذا
المقال الذي غَلَب عليه التّوصيف (مع تعويلٍ على بديهيّات القارئ في معرفة
الصّواب)، هو من جنس محاولة فهم الواقع الكونيّ، وهو مفتاح بناء التصوُّر الشرعي.
- رابعا: أنّ مُجرَّد التّنَبُّه إلى تأثير ثقافة ما
بعد الحداثة في تشكُّل عقولنا، ومحاولة التغلُّب على هذه العلّة الصّارفة عن
الحقّ، يُخفّف من وطأة هذه الثقافة التي أتت على ما بقي من جذوة الفطرة.
ويبقى الإشكال الأعظم في ثقافة ما بعد الحداثة أنّها في
مُخرجاتها الحاليّة ليست فِكرا يستند إلى أدلّة يمكن تِعدادُها والرّدُّ عليها
-وإن كانت قائمة على أصول ومُضمَراتٍ فلسفيّة طبعا-، بل هو حالةٌ من الاندفاع
الشّهوانيّ المُتَعيّ الذي يحتاج إلى قهر، بالتّهذيب الإيمانيّ، أو الحُكم
السُّلطانيّ.
والذي أرى -ختاما- أنّه ينبغي أن يقوم به المصلِحون -كلٌّ حسب
موقعه- من أجل كسر شوكة هذه الحداثة السائلة؛ هو محاولة إحياء البديهيّات التي
قامت الحضارة المعاصرة بطمسها، وإيقاظ الفطرة التي نُسِّيَها الناس، وتذكيرهم
بأسئلتهم الكبرى التي غُيّبت عنهم بحشرهم في دوّامة رأسماليّة مُخيفة.
_____
- لاحظ أنّنا لم نستعمل هنا كلمة “تطوُّر”، مع كون هذا الاستعمال دارجا في مثل هذا السّياق، ذلك أنّنا لا نتبنّى فكرة التطوُّر السائدة، بل التغيُّر الذي قد يكون تطوُّرا أو انحطاطا.
- د. مشاعل عبد العزيز الهاجري، من تصديرها لترجمة كتاب “نظام التّفاهة” لـ د. آلان دونو، ص 31.
- أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، المجلد الأول، ص 241.
- آندريه لالاند، المصدر السابق.
- إعلان مكسيكو بشأن السياسات الثقافية، المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية، مدينة مكسيكو، 26 يوليو – 6 أغسطس 1982. https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/definition-de-la-culture-par-l-unesco.html
- زيجمونت باومان، الثقافة السائلة، ترجمة: حجاج أبو جبر، الشبكة العربية، ص 15.
- د. عبد الوهاب المسيري و د. فتحي التريكي، الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر، ص 17.
- عبد الله إبراهيم، المركزية الغربية، مؤمنون بلا حدود، منشور بتاريخ 18 يونيو 2019.
- يقصد الثقافة حسب تعريف بيير بورديو، حيث يرى هذا الأخير أنّ هذا هو المفهوم الأصلي للثقافة.
- زيجمونت باومان، الثقافة السائلة، ص 15-16.
- زيجمونت باومان، الثقافة السائلة، ص 16-17.
- زيجمونت باومان، الثقافة السائلة، ص 17-18.
- طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر، مؤسسة هنداوي، ص 43.
- طه حسين، المصدر السابق، ص 43.
- زكي نجيب محمود، هموم المثقفين، مؤسسة هنداوي، ص 12.
- زكي نجيب محمود، المصدر السابق، ص 12-13.
- بدر الدين مصطفى، دروب ما بعد الحداثة، مؤسسة هنداوي، ص 11.
- أندريه-جان أرنود، ما بعد الحداثة: دراسات في التحولات الاجتماعية والثقافية في الغرب، ترجمة: د. حارث محمد حسن ود. باسم علي خريسان، نديم للترجمة، ص 80.
- أندريه-جان أرنود، المصدر السابق، ص 80.
- د. عبد الرزاق بلعقروز، مداخل مفهومية إلى مباحث فلسفية وفكرية، مركز نماء، ص 27.
- د. الطيب بوعزة، ما بعد الحداثة وموت الإنسان، موقع الجزيرة، منشور بتاريخ 18 فبراير 2006.
- يقصد فقدان الثقافة لدورها.
- زيجمونت باومان، الثقافة السائلة، ص: 19.
- زيجمونت باومان، الثقافة السائلة، ص 20.
- زيجمونت باومان، الثقافة السائلة، ص 20.
- زيجمونت باومان الثقافة السائلة، ص 20.
- جيل ليبوفتسكي، في مقابلة “من التنظيم الجماعي إلى التّحكيم الفردي”، من ترجمتي، موقع أثارة.
- جيل ليبوفتسكي، عصر الفراغ: الفردانية المعاصرة وتحولات ما بعد الحداثة، ترجمة: حافظ إدوخراز، مركز نماء، ص 10.
- زيجمونت باومان، الحياة السائلة، ترجمة: حجاج أبو جبر، الشبكة العربية، ص 40.
- زيجمونت باومان، الثقافة السائلة، ص 21.
- السعيد لبيب، من تصديره لكتاب «في معنى ما بعد الحداثة» لـ فرانسوا ليوتار.
- جيل ليبوفتسكي، عصر الفراغ، ص 69.
- جيل ليبوفتسكي، عصر الفراغ، ص 70.
- د. البشير عصام المراكشي، من مقدّمة ترجمته لكتاب “جناية النسوية على المرأة والمجتمع”، مركز دلائل، ص 19.
- سوزان ماير، ما بعد الحداثة: دراسات في التحولات الاجتماعية والثقافية في الغرب، مصدر سابق، ص 114.
سجل تفاعلك مع المقال
تم تسجيل تفاعلكم مع "تحوُّل الثقافة منذ ما قبل الحداثة إلى ما بعد ال..."
قبل بضع ثوان


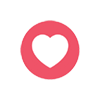
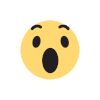

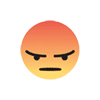

التعليقات
Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂
جزاكم الله خيراً، من أمتع وأنفع ما قرأت