“أفتراه يجيء يوم على الناس يكون أعظم اختراع فيه للإنسان الأخير أن يعيد إلى الأرض إنسانها الأول الكريم؟”
الرافعي[1].
منذ بَدْءِ الوعي الإنساني، شكل سؤال المعنى حيزا
أنطلوجيا في ميادين الفكر والمعرفة، وظل البحث عن الغرضية ينبش في مخيال الإنسانية
باختلافاتها العقائدية والمذهبية، وانطرح سؤال الكيف ولماذا، كإشكال فلسفي عميق
يؤطر حال الإنسان ومآله، وترسم الإجابة عليه مسارات الإنسان المادية والوجدانية،
فكانت معرفة النفس هي بداية كل معنى، وخيط يصل الإنسان بحقيقته الوجودية، إنها
موضوع الماضي والحاضر والمستقبل. من أنا يا ترى في الوجود؟ وما هو شأني، وما
موضعي؟ أسئلة كلية تحمل حيرة شاعر، وتأمل فيلسوف، وقلق إنسان تائه يبحث عن مخرج
وجودي، ومعنى غائي لكينونته، في ظل تضارب الرؤى والتصورات الفلسفية التي تتجاذبه،
لتلقي به في نفق اللامعنى. وما الإنسان المعاصر في صورته
المضطربة السابحة في فلك المادية، إلا انعكاس لفوضى الأيديولوجيات، التي حادت به
عن منزلته الوجودية في الكون، ونقلته من مقام الكرامة إلى منحدر البهيمية.
فإنسان ما بعد الحداثة أو الإنسان المعاصر في نموذجه
الغربي، مثال لما آل إليه الوضع الإنساني في خندق القرن الواحد والعشرين، حيث لا
صوت يعلو فوق صوت السوق، ولا سلطة إلا لمن ملك التقنية، وتفنن في مكننة الحياة
الإنسانية، إنه ترجمة لأزمة المعنى، وتشتت سبل اليقين، في حضارة اختارت العلم
والآلة بدل الإله، فكان لهذا الخيار خسران لقيمة الإنسان، الذي غُيبت روحه
المعنوية، وطمست معالمه الشعورية، فبات مغتربا عن ذاته، وسط دوامة المادية، وسطوة
المنطق النفعي، اللذين سيطرا على سير الحياة الإنسانية، ففقد الإنسان على إثرهما
بوصلة قيْميَّته، وصار شعار فينس لومباردي- الفوز هو الشيء الوحيد- قاعدته
الأخلاقية، في حلبة صراع بطلها الإنسان.
ففي عالم لا غاية له ولا هدف، لم يكن للإنسان
الحديث إلا أن يقف خاويا من كل معنى، مفرغ الروح، ماضيا إلى الهاوية، يهرب كما صرح
البسيكولوجي والفيلسوف الإنساني إريك فروم إلى إدمان الكحول، انغماس متطرف في
الجنس، وتظهر عليه أعراض كل أنواع الأمراض النفسية والجسدية، والمفارقة كما يقول
أن المجتمعات الأكثر غنى، تبدو هي الأكثر مرضا ويرتبط تقدم الطب فيها بازدياد هائل
في كافة أشكال المرض النفسي والجسدي[2]،
فأزمة الإنسان الحديث، هي نتاج تصور مادي أفقي، أفْقد في الإنسان روح الإيمان،
لمَا أنكر تركيبته الثنائية، وألغى الجانب المعنوي فيه، فما عاد ليبصر الطريق، ولا
ليستطعم جوهر الحياة، وأضحى ذرة تتقاذفها الأمواج في محيط الكون.
فاجعة الإنسان الحديث هي أزمة تصور ورؤية وضعية طينية،
مزقت الأبعاد الأنطلوجية للإنسان، ومسخت كينونته، ملقية به في جحيم المادة، فبعدما
انتقل الغرب من تلك النظرة الجيوسانترية (Géocentrisme)، التي ظلت لردح من الزمن تقود
فكره وتسيطر بلا نقاش على ميدان العلم، إلى نظرة هيليوسنترية (Héliocentrisme)، تدعمها الشواهد والقرائن
العلمية، تغير معها مفهوم العالم السائد في القرون الوسطى جذريا، كما تحولت معها
رؤية الإنسان الغربي لذاته، من رؤية دينية تربط الإنسان بالخطيئة الأصلية وعقيدة
الخلاص إلى رؤية أكثر تحررا، يضحي بها الإنسان مركزا لعالم في تطور دائم. فعصر
النهضة كان عصر الإنسان بامتياز، إنه عصر التمركز حول الإنسان، الذي جعله رواد
النزعة الإنسانية معيارا لكل شيء، فهو شمس
العالم، وليس هناك كما يقول الثيولوجي الإيطالي بيكو ديلا ميراندولا شيء بديع في العالم
أكثر منه[3]، فهو قاهر الطبيعة ومالكها،
والرحى التي يدور حولها الخطاب الهيوماني.
غير أن لوحة الرجل الفيتروفي (Homme de Vitruve) التي رسمها رواد عصر النهضة،
وأنواريو القرن الثامن عشر للإنسان الأيقونة الذي يتوسط الكون، والتي كانت رمزا من
رموز النزعة الإنسانية، وأيقونة فنية تترجم وضعية الإنسان الحديث، استبدلت بنظرة
علمية مادية أنزلته عن عرش الألوهية والسيادة، إلى الطبيعة، وقوانينها الحتمية،
التي تسري عليه كما تسري على غيره من المخلوقات، لتعلن هذه المرحلة موت الإنسان
الإله، وصعود الإنسان الطبيعة العاري من أي معنى وجودي أو غائي، الإنسان الذئب
الذي يعيش في صراع دائم للبقاء، في عالم مقطوع الصلة بالإلهي، خاضع لحكم الصدفة.
فالإنسان الذي ضاعف كما يقول ريتشارد تارناس من
سعيه للسيطرة على الطبيعة من طريق فهم مبادئها، من أجل أن يحرر نفسه من قبضة
الطبيعة، ومن أجل أن يرتفع إلى فوق هذه الطبيعة، زاد علمه من كمال إذابته
ميتافيزيقيا في بوتقة الطبيعة، وصولا، من ثَم، إلى الذوبان في شخصيتها الميكانيكية
واللاشخصية أيضا[4]، وتَبَخُّر سمته الروحية،
التي ينفصل بها عن الموجودات، ويُرَكِّب من خلالها عالمه الخاص الذي يسمو فيه إلى
مدارج الكمال الإنساني.
ففي حضارة قطعت صلتها بمدد السماء، يغيب الإنسان الميتافيزيقي
الباحث عن معنى، ليتمظهر الإنسان الطيني، في أبعاده الأرضية المادية، المنغمس في
سوق الاستهلاك الاقتصادي، الخاضع لآلية العرض والطلب، اللاهي في مستنقع اللذة،
والذي أصبحت تجربة حياته المركزية، أكثر فأكثر، أنا أملك، وأنا أستخدم، وأقل فأقل
أنا أكون[5]،
بعدما أنكر وتجاهل ثنائيته، التي بها يكون أنا لها معنى وغائية أنطلوجية، في عالم
بات يتوق إلى رؤية بديلة تنتشله من مهاوي الفراغ.
فحياة الإنسان الحقيقية كما يقول لويس مومفورد Lewis Mumford لا تكمن فقط في
أنشطة العمل التي تمده بأسباب الحياة، وإنما في الأنشطة الرمزية التي تعطي مغزى
لكل من عمليات العمل ومنتجاته النهائية[6]،
والدين من ضمن تلك الأنشطة الرمزية الأساسية التي تحيي في الإنسان روح المعنى، وفي
رحابه يجد جوابا لأسئلة الوجود والمصير، التي بها يكون إنسانا، وبدونها فهو أقرب
للبهيمية منه للإنسانية.
فالحضارة الغربية المعاصرة، تنذر كما صرح العديد من
المفكرين أمثال روجيه جارودي، وإريك فروم، وغيرهما، بخراب الإنسانية، وبوار الروح
في أفرادها، بعدما تخلت في تصورها الكوني عن الإلهي، واستبدلته برؤية علمية عاجزة
عن الإحاطة بقضايا الإنسانية الكبرى.وحضارة كهذه، لا تستطيع النفاذ إلى ماهية
الإنسان، لا يمكنها أن تجيب عن سؤال المعنى، وتخرج هوية الإنسان المطمورة في جوف
المادية العمياء، بله أن تمضي به نحو غاية شعارها “حي على الفلاح”.
وأمام هذه الرؤية الطينية القاصرة، التي أفرغت الإنسان
من قيمته الوجودية، نكون بحاجة إلى رؤية كونية تستقي من نور الوحي الإلهي، تهتم
بالإنسان كلا لا جزءا، رؤية متبصرة بحال الإنسان ومآله، تحيي روح المعنى في
الإنسان، وتطفئ لهيب الحيرة في عقله، تعيد إنسان الفطرة المتساوق مع ذاته، المنعتق
من آلية الطبيعة، الإنسان الشريف الباحث عن الغاية والهدف، لا إنسان الفوضى
والعدم.
[1] المساكين، مصطفى صادق الرافعي، دار المعرفة،
القاهر-مصر، ط1 (1437هـ-2016م)، ص(14)
[2] كينونة الإنسان، إريك فروم، ترجمة: محمد حبيب،
دار الحوار، دار الحوار، اللاذقية-سوريا، ط1 (2013م)، ص(40)
[3] De la dignité de l’homme, Jean Pic de la Mirandole, p(3),
[4] آلام العقل الغربي، ريتشارد تارناس، ترجمة: فاضل جتكر، العبيكان،
الرياض-المملكة العربية السعودية، ط1 (1431هـ-2010م)، ص( 395)
[5] كينونة الإنسان، إريك فروم، ص( 24)
[6]the
condition of Man, Lewis Mumford, Harcourt, Brace and company, New-York, (1944),
p(9)
سجل تفاعلك مع المقال
تم تسجيل تفاعلكم مع "الإنسان الحديث وأزمة المعنى"
قبل بضع ثوان


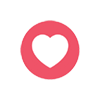
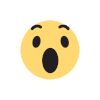

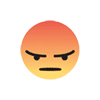

التعليقات
السلام عليكم ورحمة الله
هذه المقالة العلمية لاستاذتنا الكريمة جديرة بالقراءة لما تحمله في طياتها من المعاني الكلية عن الإنسان بشقيه (الجسد و الروح). مجسدة بذلك أزمة المعنى حسب التصور الغربي.
شكر الله للأساتذة على هذه المقالة العلمية